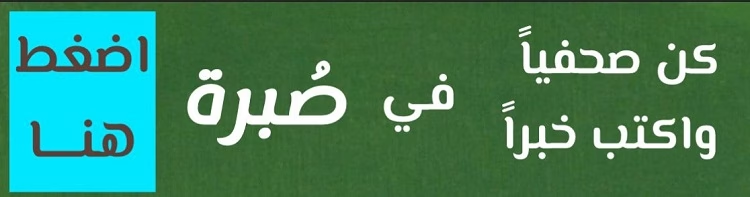اللغة – تحاورية الفهم
جمال رسول
نسق: في البدء كانت الكلمة
د. أحمد محمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة، دراسة في قضية اللغة العربية الوسطى، ص53
“في البدء كانت الكلمة كما يقال، ذلك لأن عماد كل لغة في الأصل هو ألفاظها وصيغها، وروحها وجوهرها الأساس في مفرداتها، وليس في تراكيبها كما يعتقد البعض ولا في قواعد نحوها التي تنظم هذه التراكيب ولا في قواعد البلاغة، ذلك التراكيب تتكون وتؤلف في الأصل من المفردات، ولولا المفردات لما كانت هناك تراكيب. أما قواعد النحو فوظيفتها الأساسية هي تنظيم العلاقات بين الكلمات أو المفردات والتراكيب من أجل بناء جمل وعبارات فصيحة واضحة المعاني. في حين تنحصر وظيفة قواعد البلاغة في تنظيم وتنسيق العلاقات بين هذه الجمل والعبارات بما يوافقها من وجوه حسن البيان وأساليب القول”.
قبل أربعين عاماً حينما كنا هناك، ومنذ تلك اللحظة التي كنا نعد فيها أنفسنا كان لدينا ما يبرر بل ما يثير اهتمامنا لنصرف جهودنا في سياق ما يجعل الحياة في أعيننا تبدو على قدر كبير من البروز والفكر والأدب. الشغف كان دافعنا، وبشكل ما كنا جميعا نقدم تعريفا في منزلة البدء يثري توجهنا الأدبي. كل منا كان لديه تساؤل وكان لديه إجابة، كل منا كان يتبع تدرجه الخفي.
كانت أمسياتنا مفعمة بوجوه ذات سمات طموحة لتكون بذرة العطاء في منتدى الفكر والأدب – منتدى الغدير الأدبي.
في إحدى أمسياتنا، كان اجتماعنا، وكانت عادة لنا أن نجتمع بشكل دوري أسبوعيا، في إطار لوحة ترسمها الكلمة التي نتقنها فنا. هناك، حيث تتجاور الحروف فكرا ومعنى وصورا ومشاهد وحركة، وتضج الأفواه جدلا والعقول تأملا.
في تلك الأمسية طرح صديقنا الشاعر الأديب الأستاذ حسين آل رقية موضوعًا تناول فيه: “المرأة في نظر الإمام عليٍّ عليه السلام”، في محاولة لسبر غور النص ربما بأدوات خارج الكلمة المفردة نحوا، خارج تركيب الجملة بلاغة. طرح له ذوقه وعمقه الخاص بما يمكن أن أصفه ترفا فكريا بطابع أدبي. طرح في محاولة الإبداع والتجديد في القراءة. لقد كان حقا بارعا في تنميط أسلوبه وفي استثارة فكره، وقد أضفت الروئ المختلفة جدلا حادا يتلاقح انتاجا معرفيا وقناعات مربكة في ظل تفاعل صخب حتما بنواتج جديدة مختلفة.
كان يفترض بنا أن نعيد قراءة طرحه ونستوعب أفقه، ولكن لم يتوفر لدينا ذلك الجهد.
مسار الأمسية لم يظل في إطار فكرته الموضوعية، إذ وجد طريقا آخر تحوّل به النقاش من مضمون إلى منهج، ومن كلام في المرأة إلى نقاش في كيفية قراءة النص ذاته، أي نص. لقد وجدنا أنفسنا، من غير تخطيط مسبق ولا موقف متوقع، أمام سؤالٍ كبير: بأيّ أدواتٍ يمكن أن يُقرأ كلام الإمام ع؟ ما السبيل إلى أن تنفتح معانيه على القلوب والعقول دون أن تُحبس في قوالب جاهزة -نحوا، بلاغة، منطقا…. – أو تأويلات عابرة – حرفيا، مقاصديا، رمزيا، عقليا…؟
لقد كنا حينئذ أشبه متفقين على أن النحو والبلاغة أدوات مُفسِّرةٌ للنص، ولكننا في وقت آخر وربما لاحقا قد تكون قناعاتنا متحفظة أو متغيرة فترى أنها -النحو والبلاغة- في الحقيقة أدوات مفَسَّرة بالنص.
لم يكن ذلك الحوار موضوعيا – في ذات الموضوع – بقدر ما تكشَّف لدينا وعيا بطبيعة الفهم نفسه أنّ النص ليس كلماتٍ تُتلى، بل هو أفق مفتوح على مدارس مختلفة، لا يُدرك إلا بامتلاك مفاتيح التأويل، غير أنها ليست هي التي قد عهدناها في أذهاننا.
أجل، لدينا القدرة على الإصغاء، فلماذا لا يكون لدينا القدرة على النطق حين نعود إلى الروح التي تنبض حروفها؟ ترى ما الذي يمكن أن ينطق ولا ينطق، وما الذي يمكن أن يستنطق ولا يستنطق؟
هكذا تحوّلت تلك الأمسية إلى درس ضمنيّ، ليس عن المرأة، ليس عن الرجل، إنما عن اللغة باعتبارها تحاور وحياة تعاش من أجل الوصول إلى الحقيقة، عن أدوات الفهم باعتبارها سفرا تأمليا في عمق النص، حيث يلتقي العقل بالبصيرة دون أن نختزل ذواتنا وفهمنا.
نظرية جريئة:
في مسار الفكر والتأمل هناك دائما منعرج على شكل منعطف أو بروز تتجلى فيه إشارات رمزية أو خفية أو من وراء ستار أو لعلها منكشفة لأنظار ثاقبة. في مثل هذا المنعطف يذكر أحد العلماء دام ظله الوارف تنظيرا يختصه يفتح العقل على فسحة رحبة من التفكير، وتمنحه -العقل- سكينة التأمل ليبوح بيرقُ الحقيقة بصفاء الاكتشاف. أنا هنا سأبيح لنفسي اختزال ذلك في كلمات تحمل معنىَ أستطيع أن أقول أنّي فهمته من قوله: إن اللغة تحاورية هدفها تواصلي، هي ليست مجرد أداة نقل، هي حياة تعاش وتفاعل متصل، ولا تخضع النصوص لتشريح نحوي أو بلاغي أو أدبي، بل عمق لا يرى ينبثق جذرا، وصمت يمتد ظلا، وخفاء يتدفق نبعا، وحجاب يلمع ضوءا، إنها حياة ليست خاضعة للحس وإنما وجدان وشعور، هي حضور ثنائي بين الملقي وبين المتلقي.
وبناء على هذا التصور تفقد قواعد اللغة ومفاهيم البلاغة وزنها الأساس في الاستنطاق والفهم، ولا تأثير لها على المعنى التواصلي الحقيقي، فلا استجلاء لها إلا بالنص، والنص نظام (بيئة، مدخلات، تفاعلات، نواتج). والداخل والناتج فهم ليس خاضعا تحت تأثير تلك القواعد والمفاهيم، ولا يخضع لتلك القوالب المعدة لاحقا بمعايشة بشرية ما، ولكن حضور القلب والعقل معا في النص نقاء وصفاء للفهم.
هذا الطرح عميق يمتلأ جرأة فلسفية على قلب ما هو مستقر في الدراسات لغوية وأصولية.
تلخيص النظرية في عدة نقاط:
1. ماهية اللغة: يرى أن اللغة تحاورية وظيفتها التواصل، لا مجال فيها لتعقيدات القواعد والبلاغة التي هي عنده مجرد اصطلاحات بشرية ثانوية.
2. فهم النص: لا يتوقف – بناء على تنظيره – على دقائق النحو والبلاغة، ولا على المناقشات الفلسفية المعقدة، لأن النص حاكم ولا يخضع لقوانين البيان البشرية المحدَثة، بل هو يتجاوزها.
3. النص: في الأصل أوسع من مناهج الاجتهاد الاصطناعية؛ ومن ثم فإن الاستنباط الأصيل لا يتحقق إلا عبر المعاناة والكون في بيئة النص كحياة إزاء حياة، أي أن القارئ يعيش النص ويتشرَّبه حتى ينطق من خلاله.
4. خصوصية الفهم: هذا الفهم متاح حينما تعيش النص على نحو الحضور ملكة وروحية عالية كما هو الحال في الخطاب المباشر.
إذن، من الخطأ الإفراط في تقديس القواعد والأدوات حتى تصبح حاجزا عن النص، فقد يؤدي إلى اضطراب في الفهم.
إضافة إلى ذلك:
أولا: إن الأخذ بالقواعد نحوا وبلاغة، يعني أن يكون القارئ في قالب غيره وليس محاولة لفهم النص في تقلبه.
وثانيا: لا تنحصر قواعد ضبط فهم النص فقط في تلك القواعد البشرية المخترعة، هذه أدوات بشرية تساعد على شحذ ذهني وقوة تفكير وبما أنها كذلك فاستنطاق النص كشف لها لا كشف بها.
وبمعنى آخر:
1. القوالب البشرية ليست شرطًا لفهم النص: استعمال القواعد والبلاغة يعني أنك تفهم النص وفق منطق من سبقك لا وفق النص نفسه، فتكون أسيرا لقالب آخر لا لروح النص.
2. الفرق بين الأداة والغاية: القواعد والبلاغة والفلسفة مجرّد وسائل تدريبية لشحذ الذهن وتنمية القدرة على التفكير، لكنها ليست أدوات يُستند إليها مباشرة في فهم النص. فهي تمرين ذهني لا آلة اجتهادية.
3. النص هو الأصل: فضبط الفهم لا ينحصر في هذه الوسائل البشرية، بل يُبنى على النص نفسه، لأن النص أوسع وأعمق من أن يُحصر في قوالب بشرية جزئية.
فمنطق نظريته إذن:
أن النماذج التاريخية لكثير من المسائل التي اشتهر فيها توظيف القواعد النحوية والبلاغية (كـالأمر للوجوب، أو دلالة العموم والخصوص)، تصدق هذه الدعوى في نفيها.
فإن دلالة الأمر على الوجوب، أو استفادة العموم والخصوص ليست من المسائل النحوية أو البلاغية، وكذلك ليس اختبار الصدق والكذب أيضا من تلك المسائل، ولهذا إن اللغة التحاورية أي المكتسبة بالتحاور تواصلية المبدأ والهدف نقل الفهم، وأنها ليست مدينة في التواصل والفهم على شيء من التقييد طالما هناك فعلا تواصل تحاوري يبنى عليه بين المتحاورين.
وهنا إعادة تأسيس معنى اللغة لا على النحو والبلاغة، بل على التحاور والتواصل، ولتوضيح ذلك أكثر:
أولا: اللغة تحاورية وإن أصلها التبادل الحواري بين المتحاورين، وليست نظاما مُسبَقا من القواعد المجرّدة. هي ظاهرة اجتماعية حيّة تُكتسب بالاستعمال لا بالاصطلاح الأكاديمي.
ثانيا: اللغة تواصلية وظيفتها إيصال المعنى، فإذا تحقق التواصل التحاوري لم تعد هناك حاجة إلى وسائط زائدة مثل النحو والبلاغة. فالمهم أن يحصل الفهم المشترك بين المتحاورين.
ثالثا: الأمر والعموم والخصوص وما يستند إليه الأصوليون هناك ليس نحوًا أو بلاغة، بل هو تحليل دلالي تواصلي من حيث كيف يُفهم الخطاب بين المتكلم والسامع؟ وما الذي ينعقد بينهما من التفاهم؟
فمثلاً: دلالة الأمر على الوجوب ليست استنباطًا من قواعد لغوية، بل من طبيعة التفاهم بين المتخاطبين: إذا قال المتكلم “افعل” بلا قرينة، فهم السامع أنه يريد الإلزام، لأن هذا هو المعهود في مقام التحاور.
وكذلك العموم والخصوص: هي ليست قاعدة نحوية بقدر ما هي تحليل لطريقة الاستعمال التواصلي بين المتكلمين.
رابعا: الصدق والكذب، وما يختبره المناطقة ويحلله الفلاسفة هو في غاية البعد عن تلك المسائل، بل يتخذ مسارات مختلفة في الرصد تتجاوز مستويات عدة، فحينما يكون
الاختبار:
• للواقع فسيكون منطقيا
• للاعتقاد فسيكون نفسيا
• للنية فسيكون أخلاقيا
• لقابلية الإثبات فسيكون برهانيا
• لجدواه العملية فسيكون تجريبيا
• للسياق فسيكون لغويا
وهذه كلها ليست شيئا في النحو ولا شيئا في البلاغة، هي ليست إلا الفهم المتداول بين الملقي والمتلقي، هي فهم النص والخطاب.
النتيجة:
النحو والبلاغة والفلسفة ليست مصادر استنباط أو تأويل. إنما الأصل هو التواصل الحيّ الكامن في اللغة ذاتها بوصفها وسيلة تحاور. فالعبرة دائما بالتواصل لا بالقواعد، وهذا تجديد كبير في مفهوم اللغة.
فالكلام ليس فقط تراكيب الجمل، وإنما هو فعل ثنائي في عملية التواصل – كالأمر، السؤال، الخطاب.
والفهم لا يستند إلى القواعد النحوية والبلاغية، وإنما على معرفة ما الذي يحدثه المتكلم في خطابه الاجتماعي.
المعنى ليس فقط في البنية التركيبية اللغوية، وإنما في البنية التواصلية وقدرة التواصل الثنائي بين المتكلم والمتلقي. فكلمة (افعل) مثلا يفهم على أنه أمر ملزم لأن المقام التواصلي يقتضي ذلك، لا لأن القواعد تقول ذلك.
اللغة تنجح حينما الناس يتواصلون عبر قواعد ضمنية (كقول شيء بقدر الحاجة، وعدم الغموض…) وهذه القواعد ليست نحوا أو بلاغة، بل أعراف تواصلية.
نظرية السيد الخوئي ر ه في اللغة
نسق: في حقيقة الوضع
السيد الخوئي ره، دراسات في علم الأصول، تقرير السيد الهاشمي الشاهرودي، في حقيقة الوضع ص31
“والصحيح: أن الوضع أمر واقعي محض غايته من قبل الأفعال النفسانية، فهو فعل النفس، وهو التعهد والالتزام بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، كما يتفق هذا المعنى في الأفعال أيضا، نظير ما لو تعهد المولى وقال لخادمه: بأن متى رفعت العمامة من راسي فأنا أريد الشاي. ففي الألفاظ أيضا كذلك لأجل تسهيل الإفادة والاستفادة يلتزم الواضع ويتعهد بذكر اللفظ الخارجي عند إرادة المعنى المخصوص، وهذا هو حقيقة الوضع.”
يرى السيد الخوئي – قدس سره –أن اللغة أساسها التعهد بإفهام السامع، بمعنى أن كل كلام يُقال يتعهد المتكلم التزاما بتوصيل المعنى إلى السامع، وليس مجرد التعبير عن فكرة شخصية.
وأهم نقاط هذه النظرية:
1. اللغة فعل اجتماعي: فهي وسيلة لإيصال معنى من متكلم إلى سامع، والنجاح في التواصل جزء من طبيعة اللغة نفسها.
2. النية والالتزام: المتكلم مُلزَم نفسيا وملتزم عمليا أن يبذل وسعه ليكون مفهوما، والسامع يتحمل جزءا من المسؤولية بتلقي المعنى في سياق التواصل.
3. الأدوات ليست الهدف: فالقواعد، النحو، البلاغة، أدوات تساعد على تحسين الإفهام، لكنها ليست جوهر اللغة.
الأساس النظري لهذه النظرية:
اللغة ليست مجرد رموز أو أصوات أو ألفاظ لكلمات، بل عقد اجتماعي ضمني بين المتكلم والسامع: كل كلمة تحمل التزاما بالإفهام، وكل استماع يحمل مسؤولية الفهم.
التركيز ليس على الصياغة المثالية للنحو أو البلاغة، بل على تحقيق التواصل الفعّال بين الطرفين.
انسجام نظرية السيد الخوئي ره مع نظرية العالم
إذا قارنا بين نظرية السيد الخوئي ره والنظرية التحاورية التي ذكرناها سابقا فسنجد:
– أساس اللغة:
• السيد الخوئي – التعهد بإفهام السامع، أي أن المسؤولية تواصلية.
• العالم – اللغة تحاورية وظيفتها التواصل وليس القوالب.
– دور القواعد/النحو والبلاغة:
• السيد الخوئي – أدوات لتحسين الإفهام.
• العالم – أدوات شحذ ذهني، ليست جوهرية للفهم.
– المعنى:
• السيد الخوئي – ينبع من التفاعل بين المتكلم والسامع.
• العالم – ينبع من الشأن التحاوري الثنائي.
مستوى الانسجام:
هناك توافق كبير في الجوهر: كلا الطرحين يرى أن المقام التواصلي هو الأساس، وأن اللغة وسيلة للتواصل وليس مجرد صياغة نحوية أو بلاغية.
الفرق الأساسي:
أن هذا العالم يطبّق هذا المفهوم على النصوص النصية، ويجعل الاستنباط والفهم مرتبطًا بالعيش في النص.
بينما السيد الخوئي ره يقدّم وصفًا عامًا للغة كبنية تواصلية، مع إمكانية استخدام الأدوات لتعزيز الإفهام دون الخوض في تفاصيل الاستنباط والفهم.
نسق: في البدء كانت الكلمة
يوفال نوح هراري، العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري، شجرة المعرفة ص39-46
ماذا كان المميز في لغة العقلاء الجديدة الذي مكننا من غزو العالم؟
تتمحور الإجابة الأكثر شيوعا حول أن لغتنا مطواعة بشكل مذهل، إذ نستطيع أن نربط عددا محدودا من الأصوات والإشارات لننتج عددا لا نهائيا من الجمل، كل واحدة بمعنى مختلف. ولذا نستطيع أن نستوعب ونخزن ونتبادل كمية ضخمة من المعلومات عن العالم من حولنا.
أما النظرية الثانية فتؤكد أن لغتنا المتفردة تطورت كوسيلة لتبادل المعلومات عن العالم. لكن المعلومات الأهم التي استلزمت الإيصال كانت عن البشر. وليس عن الأسود وثيران البيسون. تطورت لغتنا كطريقة لتبادل النمائم. بناء على هذه النظرية فإن الإنسان العاقل حيوان اجتماعي أساسا. يشكل التعاون الاجتماعي مفتاحنا من أجل البقاء والتكاثر.
فمعرفة الأفراد -الرجال والنساء- لأماكن الأسود وثيران البيسون ليست كافية، بل الأهم لهم أن يعرفوا من في مجموعتهم يكره من، ومن ينام مع من، ومن هو الصادق، ومن هو المحتال.
قد تبدو نظرية النميمة هذه مثل مزحة، لكن عددا من الدراسات تؤيدها.
الأرجح أن النظريتين كلتيهما صحيحتان: نظرية النمائم، ونظرية “هناك أسد قرب النهر”. مع هذا فليست الميزة المتفردة للغتنا مقدرتها على نقل المعلومات حول الأشخاص والأسود، بل مقدرتها على نقل المعلومات عن أشياء ليست موجودة على الإطلاق. فحسب معرفتنا يمكن للعقلاء فقط الحديث عن كل أنواع الكيانات التي لم يشاهدوها أو يلمسوها أو يشموها أبدا.
إن القدرة على الحديث عن الخيال هي الميزة المتفردة للغة العقلاء.