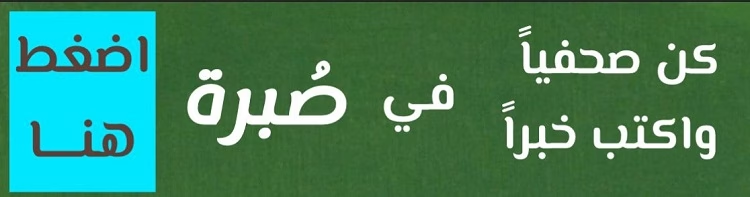كربلاء والموضوعية المستحيلة: قراءة نيتشوية في المأساة والمعنى

منتظر الشيخ
“موضوعية التاريخ”… عبارة تبدو جافة، بل وحتى مستحيلة عند تطبيقها على حدثٍ تاريخي لم يكن عابراً بل قد حرّك مسار التاريخ مثل واقعة الطف الأليمة.
فهل الموضوعية تعني التجريد العاطفي البارد عن معاناة إنسانية فادحة؟ أم تعني نبش الأرشيف بلا هوى؟ أم هي البحث عن السياقات الخفية التي صنعت الحدث؟
في مواجهة سردية سائدة قوية ومحملة بشحنة عاطفية هائلة، تصبح “الموضوعية” فعلًا ثوريًّا بحد ذاته.
إنها تشبه محاولة فهم أسطورة سيزيف – التي تناولنا تكرارها في سياق الحسين عليه السلام – ليس كحلقة مفرغة فحسب، بل كاستعارة عن التمرد المستمر.
قراءة التاريخ الحسيني بموضوعية هي استعادة للحدث من براثن القراءات الأحادية، سواء كانت تبجيلية ترفض النقد أو تشويهية ترفض الجوهر، بحثًا عن الحقيقة الإنسانية والتاريخية المتعددة الأوجه التي تثري الفهم وتُعمِّق الإيمان بجوهر الرسالة لا بالأسطورة.
كانت هذه الفكرة تومض في ذهني وأنا أستمع إلى محاضرة السيد منير الخباز التي ألقاها في الليلة الأولى من محرم لهذا العام في المركز الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان: “كيف نستثمر العظة والعبرة من سنن التاريخ؟”. محاضرة دار محورها حول قراءة التاريخ، وسبقه عرضٌ مميز لعدد من المدارس الفلسفية في قراءة التاريخ.
تحدّث السيد عن المدرسة القسرية التي ترى أن التاريخ يسير بإرادة الغلبة والقهر، والمدرسة التحليلية التي تبحث في أنماط الوعي والبنية، والمدرسة المادية التي ربطها بكارل ماركس، حيث يصبح الاقتصاد محركًا أساسيًا لمسيرة الإنسان.
وقد أشار إلى أن التاريخ هو مسيرة الإنسان، لا مجرد سجل للوقائع. ومع أن هذه الأطروحات تشكّل مفاتيح مهمة لفهم التاريخ، إلا أنني شعرت بأن المنبر لا يزال يمرّ بها مرورًا عابرًا، دون أن يسمح لها بخلخلة بنية الخطاب العاطفي المترسخ للتاريخ.
هنا، تتعالى في ذهني أصوات أخرى: صوت نيتشه مثلًا، الفيلسوف الذي لا يثق بالدموع، ولا يركن إلى القيم الموروثة، بل ينقّب عنها بمعول التفكيك. في فكر نيتشه، ليس التاريخ مخزنًا للبطولات ولا مدفنًا للمآسي، بل مسرحًا لصراع الإرادات.
واقعة كربلاء من هذا المنظور ليست مأساة تنتهي عند حدود الدم والدمع، بل فعل تمرد وجودي يواجه منظومة قيم أخلاقية سائدة. هنا يفترق الطريق بين الحسين بوصفه ضحية – كما يُقدَّم غالبًا – والحسين بوصفه فاعلًا أخلاقيًا حرًّا، اختار بإرادته أن يواجه قبح العالم لا بالخضوع، بل بالوقوف.
نيتشه يسخر من الأخلاق التي تجعل من الضعف فضيلة، ومن الانكسار طريقًا للخلاص. في المقابل، هو يقدّس “إرادة القوة”، ذلك النزوع الداخلي نحو الحياة، نحو التمرد، نحو تجاوز الذات. الحسين، حين نقرأه بهذا المفهوم، لم يكن ينتظر النجاة، ولا يسعى خلف الشهادة بوصفها خاتمة ميتافيزيقية، بل مارس أقصى درجات الإرادة في وجه سلطة قررت أن تفرض الخضوع كقدرٍ سياسي وديني.
الموضوعية في هذا السياق ليست التجرد من الحزن، بل الترفع عن استهلاك المأساة. هي رفض لاختزال كربلاء في الدموع، وفي ذات الوقت رفض لردّها إلى مجرد صراع سياسي. إنها، كما يقول نيتشه عن التاريخ النقدي، محاولة لتحرير الماضي من سطوة الاستخدام العقائدي والمزاجي، وإعادته إلى حقيقته كمجال للصراع الإنساني حول المعنى.
ما يُقلق نيتشه – وربما يُقلقنا معه – هو حين تتحول القيم الكبرى إلى طقوس، والوعي إلى شعيرة، والمقاومة إلى عادة موسمية. حينها تُدفن الفكرة التي مات من أجلها الحسين تحت ركام من التكرار الخامل. فهل نُحيي كربلاء عندما نبكيها، أم عندما نعيد مساءلتها؟ هل نكون أوفياء لدم الحسين حين نلطم، أم حين نضع أصبعنا على جرح الحقيقة: لماذا صمت الناس؟ ولماذا وقف الحسين وحده؟ ولماذا نعيد تمثيل المأساة، ولا نمنع تكرارها؟
في مواجهة هذه الأسئلة، يصبح الخطاب العاشورائي بحاجة ماسة إلى تفكيك، لا بهدف الإنكار أو الهدم، بل بهدف التجديد. إن الحسين الذي نحتاجه اليوم ليس الرمز الذي يعفينا من التفكير، بل الإنسان الذي يستفز فينا شجاعة النظر إلى القبح، ثم تجاوزه. وهذه الشجاعة لا يمنحها إلا وعي موضوعي، لا يخاف من مواجهة التراث، ولا من تحرير البطولة من أسطورتها.
الموضوعية، إذًا، ليست نقيضًا للعاطفة، بل هي ما يحرر العاطفة من الوقوع في التكرار. وهي ما يجعل من كربلاء حدثًا حيًا، لا ذكرى ميتة.
وكما قال نيتشه: “من له لماذا يعيش من أجلها، يستطيع تحمل كل كيف”. ونحن، حين نسأل عن “لماذا” كربلاء، ربما نقترب خطوة نحو فهم “كيف” نصنع عاشوراء لا تتكرر، بل تُلهم.